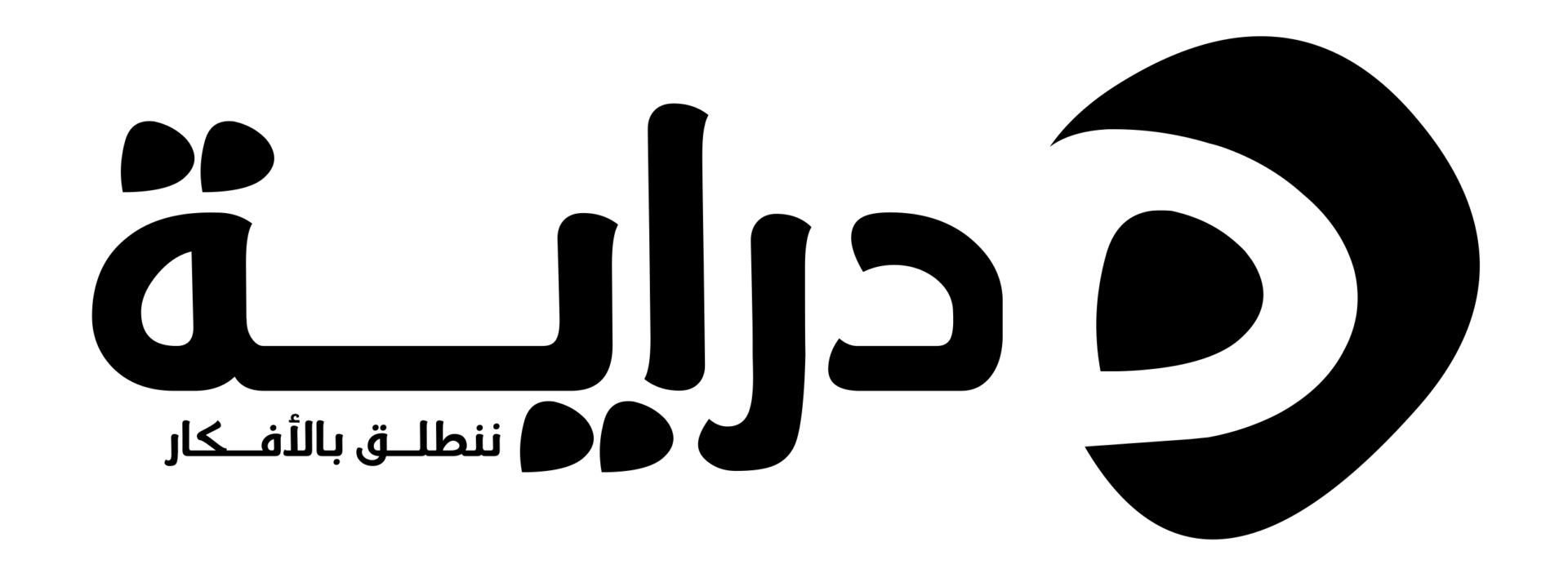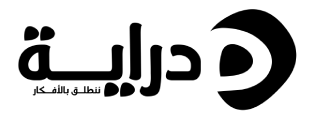- لماذا تختبر فكرة التطبيق؟
- ماذا تحتاج قبل اختبار فكرة تطبيقك الذكيّ؟
- 1- تحليل توجّهات السوق وأهم المنافسين
- 2- تحديد فئات الجمهور المُستهدَف
- 3- تجهيز القيمة المُقتَرَحة والقيمة المُضافة للتطبيق
- 3 خطوات لاختبار فكرة التطبيق عملياً
- أولاً: تحضير النموذج الأوّلي التطبيق (Prototype)
- ثانياً: إجراء المقابلات الشخصية وعمل الاستبيانات والاستطلاعات
- ثالثاً: تحليل النتائج وتقييمها
- أخيراً: امضِ قُدماً أو عَدِّل الفكرة وفقاً للمعلومات
تنبيه: هذا المقال موجه للذين يبذلون جهداً مُضنياً في ادّخار القروش والدراهم وحفظها، لذلك فهم لا يدّخرون جهدهم أيضاً في دراسة أفكار مشاريعهم قبل إطلاقها، في محاولة جادة للتنبؤ بمستقبل أفكارهم. لا تختبر فكرة تطبيقك الذكي إلا إن كانت مواردك من الوقت والجهد والمال لا تنضب!
هل راودتك يوماً فكرةُ تطبيقٍ ذكيٍّ أضاءت عقلك كالبرق، ثم تبخّرت بمجرد التفكير في: “ماذا لو..؟”.
هل تخيلت يوماً أنك تبني قصراً شاهقاً فوق رمال متحركة؟ هذا بالضبط ما تفعله عندما تُطلق تطبيقاً دون اختبار فكرته!
تخيّل لو كان بين يديك خريطة تكشف لك مسبقاً سرّ نجاح فكرتك أو سبب سقوطها قبل أن تكتب سطراً برمجياً واحداً! استعد لاختبار جدوى فكرتك بذكاء قبل أن تندفع في تنفيذها، فتتحوّل إلى مجرد ذكرى عابرة في متاجر التطبيقات..
لماذا تختبر فكرة التطبيق؟
اختبار الفكرة (Idea Validation) ضروري لتحفظ مالك ووقتك الثمين من الضياع في مشروعٍ غير واعد، وسيسمح لك بالاستثمار في مشاريع أقرب للنجاح منها إلى الفشل.
اختبارُ الفكرة (Idea Validation) ضروري لتستثمر مواردك في مشاريع أقرب للنجاح منها إلى الفشل.
قبل أن نستعرض أهم الاستراتيجيات العمليّة لاختبار فكرتك، لنبدأ بمعرفة الأشياء الضرورية التي عليك إنجازُها قبل خطوة الاختبار حتى تتخذ قرارك بثقة سواءً كانت فكرتك تستحق التطبيق فعلاً أم تحتاج مزيداً من النُضج لتكون مناسبة.
ماذا تحتاج قبل اختبار فكرة تطبيقك الذكيّ؟
1- تحليل توجّهات السوق وأهم المنافسين
من أسهل الطرق لدِراسة توجّهات السوق (Market Trends) هي الاعتماد على الأدلة والتقارير المُتاحة التي تُصدرها جهات حكومية أو مجلات علمية أو أكاديمية حول السوق الذي تستهدفه.
أي أن هذه التقارير توفّر الوقت والمال في إجراء الأبحاث بنفسك ولكنّها غير مُخصّصة أو مُعدّة لتُناسب فكرة تطبيقك بالتحديد، كما أنها قد تكون غير مُحدَّثة.
ومن الأمثلة على هذه التقارير:
- آفاق القطاع غير الربحي: رحلة الريال إلى 100 مليار (أصدرته مؤسسة الملك خالد).
- تقرير المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2023 (أصدرته المركز الوطني للتعليم الإلكتروني).
- مجموعة بيانات وزارة الصحة (مُتاحة عبر منصة البيانات المفتوحة).
بعد تحليل توجّهات السوق، جهّز قائمة بأهم التطبيقات المُنافسة وأقربها لتطبيقك من حيث الفكرة أو القيمة المُقترحة أو الجمهور المُستهدَف، ثم حلِّل كل تطبيق مُستعيناً بالجدول التالي:
| تطبيق مُنافِس #1 | تطبيق مُنافِس #2 | تطبيق مُنافِس #3 | |
|---|---|---|---|
| الجمهور المُستهدَف | |||
| أبرز خصائص التطبيق | |||
| القيمة المُقترحة للتطبيق | |||
| تجربة المُستخدم (UX) | |||
| واجهة المُستخدم (UI) | |||
| عدد التحميلات في المتاجر | |||
| التقييم في متجر الألعاب | |||
| المزايا أو نقاط القوة في التطبيق | |||
| الفجوات أو نقاط الضعف في التطبيق | |||
| التقييم الكلّي للتطبيق في نظرك (من 10) |
سيمكّنك تحليل المُنافسين من تصوّر السوق المُستهدَف بوضوح. بعد تحليل المنافسين اسأل نفسك مثل:
- هل يتمتع التطبيق بميزة تنافسية حقيقية تُعطيه تفردًا في السوق؟
- هل فكرتي قابلة للنسخ بسهولة من قِبل المنافسين؟
- كيف يمكن تحسين تجربة المستخدم (UX/UI) مقارنة بالمنافسين؟
- ما الاستراتيجية التي سأستخدمها لجذب مستخدمي المنافسين إلى تطبيقي؟
2- تحديد فئات الجمهور المُستهدَف
ابدأ بتكوين صورة واضحة عن الجمهور الذي تستهدفه من التطبيق، وهو الذي يستجيب لرسائلك التسويقية وعنده حاجة مُلحّة لتحميل التطبيق والاستفادة منه فعلاً.
لا شيء أحبُّ إلى النفس من اكتشاف تطبيق ذكي يُلبّي حاجتك وكأنَّه طُوِّرَ خصيصاً لك!
فاسأل: ما صفات المُستخدِم الذي سينتابه هذا الشعور عند التعرُّف إلى تطبيقك؟
لتكوّن شخصية العميل المثالي (Buyer Persona)، حدّد الآتي:
- الخصائص الديموغرافية (البلد/المنطقة، العُمر، الجنس).
- الاهتمامات والهوايات.
- المستوى التعليمي.
- الوظيفة والراتب.
- المشاكل التي تواجهه.
- الأهداف والاحتياجات.
هذه العناصر قد تزيد أو تقلّ وكل عُنصر قد يحتاج إلى تفصيل أكثر من غيره حسب فكرة التطبيق وفائدته.
عادةً يُقسَّم الجمهور المُستهدَف إلى عدة شخصيات (personas)، فمثلاً: إن كان تطبيقك – لنُسمِّهِ إجازة – يُساعد المُستخدِمين على تحديد مُستوى إجادتهم لقراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد باستخدام الذكاء الاصطناعي، فرُبما تُقَسِّم الجمهور إلى شرائح (Segments):
- المهتمّون بتعلُّم القرآن الكريم وإتقانه.
- طُلّاب كليّات العلوم الشرعية والمعاهد الدينية.
- مُحفّظو القرآن الكريم.
وكل شريحة لها صفاتُها وخصائصها المُختلفة، ولها اسمٌ مميز ليسهُل الإشارة إليه في جلسات العصف الذهني مثلاً أو أثناء تطوير التطبيق.
3- تجهيز القيمة المُقتَرَحة والقيمة المُضافة للتطبيق
قبل اختبار فكرة تطبيقك، عليك صياغة القيمة المُقترحة أو مُقترح القيمة (Value Proposition) للتطبيق الذي تفكّر في تطويره.
تُعرف القيمة المُقترحة ببيان الغرض أو القيمة التي تدفع الجمهور إلى تحميل التطبيق واستخدامه، مُقارنةً بتطبيقات أو حلول أخرى تُعالج نفس المُشكلة.
وتعد القيمة المُقترحة أحد المكونات الأساسية لنموذج العمل (Business Model).
وتتضمّن القيمة المُقترحة:
- فوائد التطبيق للمُستخدِم.
- صياغة واضحة، قصيرة، سهلة الفَهم.
- مزايا التطبيق غير المتاحة في التطبيقات أو الحلول الأخرى.
هناك عدة صيغ لتكوين القيمة المُقترحة، من أشهرها صيغة ستيف بلانك (Steve Blank):
- يُمكّن التطبيق … (الجمهور المثالي).
- من … (حاجة العميل).
- مما يُساعدهم على… (هدف العميل).
مثال للقيمة المٌُقتَرَحة لفكرة تطبيق يُدعى “هِمَّة”:
يدمِج “هِمَّة” الشباب ذوي الهِمَم بالمملكة العربية السعودية في سوق العمل عبر توفير وظائف تُناسب مهاراتهم وقدراتهم، مما يساهم في تحقيق استقلاليتهم المالية والمهنية.
لاحظ أننا طبّقنا صيغة ستيف بلانك كالآتي:
- الجمهور المثالي: “الشباب ذوي الهِمَم بالمملكة العربية السعودية”.
- حاجة العميل: “ذوي الهِمم”.
- هدف العميل: “تحقيق استقلاليتهم المالية والمهنية”.
أما القيمة المُضافة (Added Value) فتُعبِّر عن الفوائد أو الميزات الإضافية التي تتجاوز الخدمة الأساسية للتطبيق، وهي تدعم القيمة المُقتَرَحة وتزيد من استعداد لاستثمار مبلغ أعلى بسبب الإضافات أو الخدمات المُصاحِبة لمهمة التطبيق الأساسية.
مثال للقيمة المُضافة لتطبيق “هِمَّة”:
- شراكات مع شركات سعودية لتوفير وظائف مرنة تُناسب احتياجات ذوي الهِمَم الجسدية/النفسية.
- مَنْح نقاط ماليّة (مُكافآت) تُحوَّل إلى دعم مادي عند تحقيق أهداف مهنية مُعيَّنة.
- تخصيص مُرشد مهني يُرافق المستخدم خلال الأشهر الأولى من رحلته المهنية.
بعد تجهيز فئات الجمهور المُستهدَف وإعداد القيمة المُقترحة والقيمة المُضافة للتطبيق، لنتجه الآن إلى الاستراتيجيات العمليّة لاختبار الفكرة..
3 خطوات لاختبار فكرة التطبيق عملياً
أولاً: تحضير النموذج الأوّلي التطبيق (Prototype)
حان الوقت لتحويل المفهوم من مجرد فكرة أو نُسخة مُبسَّطة إلى نموذج أوّلي جاهز للاختبار يوضح تجربة المُستخدِم أو رحلة العميل، ويُطَوَّر وفقاً لاستجابة مجموعة من الجمهور المُستهدف والمطوّرين والمُصمّمين.
وقد يتضمّن النموذج الأولي من التطبيق:
- تصميم أوّلي (Mockup).
- واجهة تفاعليّة (Dashboard) قابلة للنقر.
- مُخطَّط أو إطار شبكي (Wireframe).
- مُحاكاة (Simulation) لبعض وظائف الواجهة الخلفية للتطبيق.
ستعتمد في هذه المرحلة على أدوات مثل: Figma، Adobe XD، InVision.
ملحوظة: إن كانت نتائج الانطباعات حول النموذج الأوّلي للتطبيق مُبشِّرة، فقد حان الوقت لتطوير التطبيق أو المنتج في صورته الأساسية (MVP)، وهو التطبيق بمكوّناته الأوّلية الجاهزة للاستخدام الذي يُؤكد على الجدوى منه ويثبت وجود حاجة مُلحّة عند الجمهور المُستهدَف لاستخدامه. بعد ذلك تستقبل الآراء لتطوير التطبيق في نسخته النهائية.
في «معمل الأفكار»، نحلل فكرتك ونختبرها ونطوّرها مُستعينين بدراسة السوق والمنافسين وجلسات العصف الذهني والنمذجة.
ثانياً: إجراء المقابلات الشخصية وعمل الاستبيانات والاستطلاعات
الاستبيانات والمقابلات من أخصر الطرق لاختبار جدوى تطبيق أو مشروع ما، فتُطرح الأسئلة على عيّنة من الجمهور المُستهدَف وتُسجَّل وتُحلّل إجاباتها لتكوين رؤية واضحة حول انطباعات الجمهور عن فكرة ما.
وتنقسم البيانات المأخوذة من المُقابلات والاستبيانات إلى:
- بيانات كَيْفيّة/نَوْعية (Qualitative Data): تنتج من الأسئلة المفتوحة مثل: كيف تصف تجربتك في استخدام منصات التبرّع عبر الإنترنت؟
- بيانات كمّية (Quantitative Data): تنتج من الأسئلة المُحدّدة التي تتضمن قيماً عددية أو أرقاماً، أو أسئلة مُغلفة إجابتها “نعم/لا”.
بعض الأفكار لأسئلة المُقابلات والاستطلاعات لفكرة تطبيق يُدعى “فضولي” الذي يوفّر تجارب علمية آمنة للمُراهقين، يُمكن تنفيذها باستخدام مواد متوفرة في المنزل، تُعزِّز فهمهم ويُنمِّي مهاراتهم العملية:
1- أسئلة البيانات النَوْعية:
- هل قمت سابقًا بإجراء تجارب علمية في المنزل؟ وكيف كانت تجربتك؟
- كيف ترى فكرة تطبيق يُقدّم تجارب علمية آمنة باستخدام مواد منزلية؟
- ما هي الميزات التي تتمنى توفرها (مثلاً: تعليمات فيديو، خطوات تفاعلية، تقييمات أو مسابقات)؟
- هل لديك اقتراحات لتحسين الفكرة أو لجعل التجارب أكثر سهولة ومتعة؟
2- أسئلة البيانات الكَمِّية:
- هل ترى أن التطبيق سيحفزك على استكشاف المزيد من مفاهيم العلوم؟ (نعم/لا/ربما)
- كم مرة تتوقع استخدام التطبيق؟ (يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا).
- هل مستعد لدفع اشتراك شهري في التطبيق لاستخدامه؟
- ما نوع التجارب التي تفضل تجربتها؟ (الكيمياء، الفيزياء، الأحياء)
ثالثاً: تحليل النتائج وتقييمها
بعد جمع البيانات الكمية والنوعية من المقابلات والنموذج الأوّلي للتطبيق، حان الوقت لفرز تلك البيانات المُتناثرة وترتيبها لتغدو أكثر وضوحاً. ابحث عن التعليقات المُتكررة والأنماط الخفية لتتخذ القرار المناسب.
- حلِّل البيانات النَوْعيّة: صنِّف الإجابات إلى نقاط قوة، نقاط ضعف، اقتراحات للتحسين.
- حلِّل البيانات الكَمِّية: احسب النسبة المئوية للإجابات الإيجابية والسلبية، واستخدم الرسوم البيانية لتصوّر النتائج بشكل أفضل.
أخيراً: امضِ قُدماً أو عَدِّل الفكرة وفقاً للمعلومات
بناءً على ما سبق، ستتضح لك اتجاهات وسلوكيات المستخدمين وآراء المُطوّرين والمُصمّمين حول تطبيقك، والتي ستساعدك في اتخاذ القرار وتلهمك العديد من الميزات والأفكار الإضافية التي ربما لم تنتبه لها من قبل.
المراجع
- MVP – ترجمة وتعريف مصطلح الحد الأدنى من المنتج بالعربية
- شرح معنى ” منتج الحد الأدنى ” ( Minimum Viable Product ) | دليل مصطلحات هارفارد بزنس ريفيو
- Project Management Terms: A to Z Glossary | Coursera
- 3 Steps to Validate Your App Idea
- How to Validate Your Side Hustle Idea in 1-Hour
- What Is Proof of Concept? POC Examples & Writing Guide [2025] • Asana
- The Ultimate Guide to Creating Buyer Personas (2024) – Shopify
- How to Create a Value Proposition for Your App
- What is User Research? | IxDF
انتَفَعْت من المقال؟
شارِكْ المعرفة مع زملائك المُهتمين!